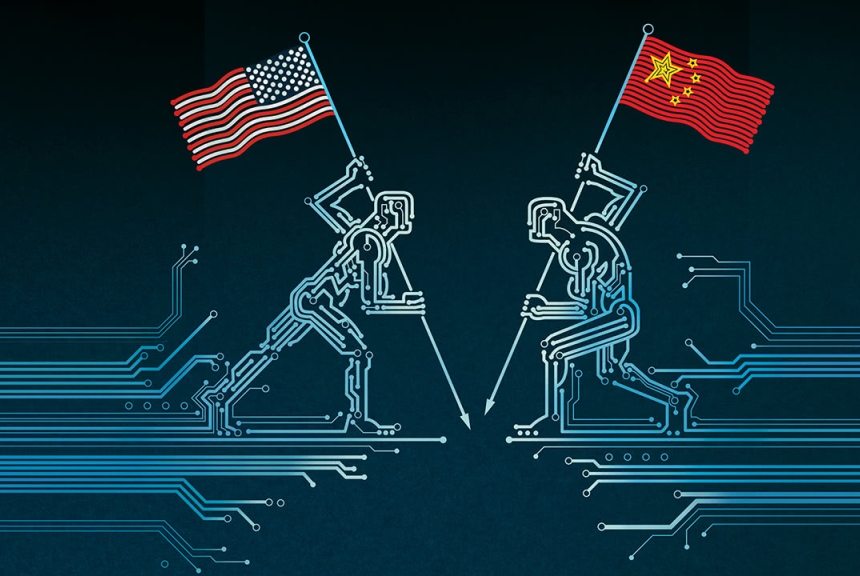لا يمكن المنافسة أن تصبح غايةً في ذاتها؛ تتحوّل المنافسة القائمة بين الولايات المتحدة والصين إلى شغل واشنطن الشاغل، إلى درجةٍ حدت بمستشار الأمن القومي، جايك سوليفان، إلى التحذير – قبل تولّيه منصبه – من مغبة الانحراف نحو «المنافسة من أجل المنافسة»، بفعل الفشل في ربط الوسائل بالغايات. مسارٌ سيتأتّى عنه، في ما لو استمرّ تصاعديّاً، الوقوع في دائرة مواجهة خطيرة، أصبحت، في نظر أغلب المحلّلين، حتميّة، ما لَم تُبدّل أميركا نهجَها الانفعالي بآخر أكثر واقعية. ولأن «التفوّق» على الصين يسكن الوجدان الأميركي، تُحدَّد على أساسه معايير النجاح والفشل، وإنْ كانت التصنيفات بناءً رمزيّاً أكثر منها شرطاً موضوعيّاً، ما يعني أن الولايات المتحدة «لا تحتاج إلى هزيمة الصين من أجل الفوز»، والتعبير لجيسيكا تشين فايس، أستاذة دراسات الصين وآسيا والمحيط الهادئ في جامعة كورنيل.
تجذب «مكانة الصين» في عهد الرئيس شي جين بينغ، والتحدّي الذي تمثّله للقوّة الأميركية، اهتماماً تحليليّاً مستفاضاً. وهناك اعتقاد غالب، في أوساط النُخب الأميركية، بأن المواجهة قائمة بالفعل، لدحر الخطر الذي تُشكّله الصين على «النظام العالمي القائم على القواعد». مع هذا، يفتح كيفن رود، وهو رئيس الوزراء الأسترالي الأسبق والخبير في الشأن الصيني، في كتابه الذي صدر أخيراً بعنوان «الحرب التي يمكن تجنُّبها: مخاطر الصراع الكارثي بين الولايات المتحدة والصين في عهد شي جين بينغ»، «نافذة أملٍ» يمكن منها «اجتناب الحرب»، وإنْ كانت أغلب المؤشرات توْصل إلى قناعة مفادها بأن «احتمال الحرب أصبح حقيقياً»، لأسباب عدة، تأتي في مقدِّمها التحوّلات السريعة في موازين القوى بين أميركا والصين، والتي رسّختها – وفق الاعتقاد الأميركي – تغييرات أدخلها شي، في عام 2014، على استراتيجية الصين الكبرى: من موقف دفاعي إلى سياسة نشطة تسعى إلى تعزيز المصالح الصينية في جميع أنحاء العالم. «تحوُّلات» استندت إليها واشنطن لتتبنّى، اعتباراً من عام 2017، استراتيجية (رسمية) جديدة تجاه الصين، فأطلقت إدارتا دونالد ترامب وجو بايدن «عصراً جديداً من المنافسة الاستراتيجية»، وضع القوّتَيْن في مسار تصادمي. وفي سياق نموّ قدرات بكين، زادت واشنطن من تحوُّطها، فوضعت إدارة باراك أوباما، في عام 2012، أُسس سياسة «الاستدارة نحو آسيا»، فيما أصبح تقييم العلاقات يستند إلى إطار أيديولوجي في عهد الإدارتَين الحالية والسابقة. رأى ترامب أن النظام الماركسي اللينيني يسعى إلى «اغتصاب» الولايات المتحدة، والهيمنة على العالم، وتقويض الديموقراطية؛ لهذا، أطلقت إدارته حرباً تجارية، وهدّدت بـ«فصل» الاقتصادَين الأميركي والصيني، حتى أن كبار المسؤولين في عهده، مِن مِثل مايك بومبيو الذي قاد «المواجهة» مع الصين، لمّحوا في خطاباتهم إلى تغيير النظام، عبر «تمكين الشعب الصيني». من جهتها، لم تأتِ إدارة بايدن على سيرة تغيير النظام، لكنها واصلت، في الوقت نفسه، اتباع السياسات التي وضعتها الإدارة السابقة.
ما تقدَّم، تجلّى بوضوح في «استراتيجية الأمن القومي» الأميركية التي أميط عنها اللثام عشية المؤتمر العشرين لـ«الحزب الشيوعي الصيني»؛ وفيها، تعطي الولايات المتحدة الأولويّة لـ«التفوّق» على الصين. «انتهت حقبة ما بعد الحرب الباردة، والمنافسة جارية بين القوى الكبرى لتشكيل ما سيأتي لاحقاً»، فيما ستكون عشرينيات القرن الحادي والعشرين «عقداً حاسماً لأميركا وللعالم». وإذا كان في ما سلف اعتراف ضمني بانتهاء الحقبة التي تشكّل على أساسها عالم أحادي القطب، لكن مساعي أميركا للحفاظ على الهيمنة تترسّخ وتزداد عدوانيّة، وهو ما يتبدّى خصوصاً في المواجهة القائمة بينها وبين روسيا في أوكرانيا. وفق سوليفان الذي طالع الوثيقة الجديدة: «سنعطي الأولويّة للحفاظ على أفضليّة تنافسية دائمة على جمهورية الصين الشعبية، مع تقييد روسيا التي لا تزال شديدة الخطورة (…) وتشكّل تهديداً مباشراً للنظام الدولي الحرّ والمفتوح»؛ أما الصين «في المقابل، فهي المنافس الوحيد الذي لديه نيّة لإعادة تشكيل النظام الدولي و(تملك) بشكل متزايد القوّة الاقتصادية والديبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية لتحقيق هذا الهدف».
يَظهر أن المنافسة مع الصين «بدأت تُنهك السياسة الخارجية الأميركية»، وفق ما تورد جيسيكا تشين فايس، في مقال بعنوان «الفخ الصيني: السياسة الأميركية الخارجية ومنطق التنافس العقيم المحفوف بالمخاطر» نُشر في «فورين أفيرز». فمع انشغال السياسيين وصانعي السياسة الأميركيين في التحدّي القائم بينهم وبين منافس يُعتبر ندّاً لبلادهم، وتختلف مصالحه وقيمه عن تلك الخاصة بالولايات المتحدة، «أصبح التركيز على مواجهة الصين يغفل المصالح والقيم الإيجابية التي ينبغي أن ترتكز عليها الاستراتيجية الأميركية». وهذا مسار من شأنه أن يفاقم مخاطر نشوب صراع كارثي، وأن يهدّد أيضاً بـ«زعزعة ديمومة الزعامة الأميركية في العالم». الحذر الأميركي «المبرّر» من دولة أصبحت في عهد شي «أشدّ استبداداً في الداخل وأكثر عدوانية في الخارج»، يكاد، وفق الكاتبة، يتحوّل إلى «خوف لاإرادي يمكن أن يعيد تشكيل السياسة الأميركية والمجتمع بطرق مضرّة ومؤذية»، وسط انشغال واشنطن بـ«تحديد مفهوم النجاح، أو حتى حالة استقرار، بعيداً من النصر الكامل أو الهزيمة الكاملة، يكون مقبولاً من حكومتَي الدولتَين، وبتكلفة يكون المواطنون والشركات وأصحاب المصلحة الآخرين على استعداد لتحمُّلها». ولكن «من دون إدراك واضح لما تسعى إليه الولايات المتحدة، أو بعض الإجماع المحلّي حول الطريقة التي ينبغي أن تعتمدها في علاقتها مع العالم، أصبحت السياسة الخارجية الأميركية انفعالية، وتدور في حلقات مفرغة». فمن جهة، تسعى واشنطن إلى إدامة تفوّقها وتكريس نظام دولي يفضّل مصالحها وقيمها، فيما ترى الصين – من جهة أخرى – أن النفاق والإهمال أضعفا القيادة الأميركية، ما يوفّر فرصة لإجبار الآخرين على القبول بنفوذها وشرعيتها. وتخلص تشين فايس إلى أن الجانبَين يعرفان أنه لا مفرّ من الأزمة، «لأن قواعد الإنصاف والتعايش المقبولة لن تأتي إلّا بعد هذا النوع من المواجهة المباشرة التي اتّسمت بها السنوات الأولى من الحرب الباردة».
عن التحوّلات الهيكلية في موازين القوى، كتب غراهام أليسون عن «فخ ثيوسيديدس»، وهو المفهوم القائل إنه «عندما تقوم دولة صاعدة بتحدّي قوّة قائمة وراسخة، ستنشأ حرب من أجل الهيمنة في كثير من الأحيان». وإذ يُرجَّح أن تكون تايوان موقع انفجار الوضع، بعدما أدّت التغييرات في كلّ من تايبيه وبكين واستفزاز واشنطن المتصاعد، إلى وضع الجزيرة في قلْب الصراع الأميركي – الصيني، يعتقد رود أن الاستراتيجيين الأميركيين يرفضون فكرة نهوض الصين السلمي أو التنمية السلمية، وأن شكلاً من أشكال النزاع المسلّح مع بكين أمر لا مفرّ منه، ما لم تغيّر الصين اتجاهها الاستراتيجي، لذا، لم يعد السؤال في واشنطن يتمحور حول إمكانية تجنُّب مثل هذه المواجهة، ولكن متى ستحدث، وتحت أيّ ظرف.