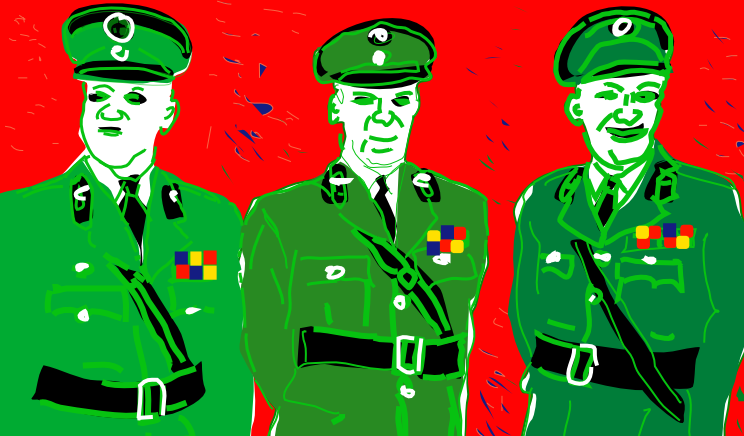ترجمة منى فرح
غالباً ما يكون حلفاء الولايات المتحدة غير مهتمين ببناء جيوش يمكنها القتال بالفعل بقدر ما تكون وظيفتها حماية الأنظمة والحكام والفساد، “فإذا لم تتعلم الولايات المتحدة من إخفاقاتها المتكررة، فلا ينبغي لها أن تتوقع نتائج مختلفة”، تقول راشيل تيكوت، المحللة السياسية الأميركية في مقالة نشرتها في “فورين أفيرز”. “كانت نتيجة الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة من أجل تعزيز قوات الأمن الأفغانية مُخزية بكل ما للكلمة من معنى. فقد أمضى الجيش الأميركي 20 عاماً في أفغانستان، وأنفق 83 مليار دولار في بناء قوة تلاشت في غضون أسابيع قليلة فقط بعد أن تنازلت عن البلاد لحركة طالبان، وهي بالكاد أطلقت رصاصة واحدة. إن الإنهيار السريع لقوات الأمن الأفغانية ليس بالأمر الخارج عن المألوف. في الواقع، ما حدث يكاد يكون “قاعدة سلوك”، أو شيئاً عادياً لا بل ونموذجياً ايضاً، يتكرر مع كل قوة أمنية يعمل الجيش الأميركي على بنائها. فمثلاً، ثلاثة من أكبر الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة لبناء جيوش حليفة – في فيتنام والعراق والآن أفغانستان ـ ُنيت بفشل ذريع. ثمة سبب وجيه لاستحضار تجربتي سايغون (فيتنام) عام 1975 والموصل (العراق) عام 2014 من الصور الواردة من كابول (…). في أفغانستان، وطوال المدة التي قضاها الجيش الأميركي في تقديم المشورة والتدريب، أثبت الضباط الأفغان أن اهتمامهم بمكافحة الفساد المستشري داخل حكومة كابول كان أقل بكثير من اهتمامهم بكيفية تأمين ثراءهم الشخصي، واختلاس الدولارات الأميركية لحساب شبكاتهم الخاصة بهم من خلال استغلال اتفاقية التعاقد وافتعال تهديدات ضد الشعب الأفغاني. أما الجنود، الذين كانوا يرون فساد ضباطهم بأعينهم، فهذا جعلهم غير مستعدين بتاتاً للتقيد بأوامر وتعليمات هؤلاء القادة، وغير مستعدين للموت تحت إمرة قيادة فاسدة. وبالتالي، لا عجب إذن أن الوحدات الأفغانية كانت غير منضبطة، وضعيفة من الناحية التكتيكية قبل وقت طويل من انسحاب الولايات المتحدة، وأن كثيرين اختاروا الترحيب بعودة طالبان بعد إنسحاب الأميركيين (…). النظرة إلى “الشركاء” إن العقيدة التي بموجبها يجري توجيه المهام الاستشارية العسكرية الأميركية تقوم على ثني المستشارين عن استخدام “سياسة العصا والجزرة” لإقناع القادة المحليين بانجاز ما يُطلب منهم بكفاءة وجدارة، واتباع السلسلة التراتبية في هرم القيادة، والتقيد بقوانين التدريب الصارم، ومكافحة الفساد. على سبيل المثال، واحد من الكُتيبات الخاصة بالجيش الأميركي يُثني المستشارين، صراحة، عن استخدام “الرشوة أو الإكراه، لأن النتائج التي تحققت من هكذا إجراءات تكون مؤقتة فقط”. وبدلاً من ذلك، تنص عقيدة الجيش الأميركي على استراتيجية الإقناع المستندة إلى العلاقات المتبادلة. يتم تعليم المستشارين العسكريين الأميركيين على كيفية إعطاء الأولوية لبناء علاقات متينة مع نظرائهم، إنطلاقاً من مبدأ أن “الثقة، والثقة المتبادلة تحددان مدى قدرة المستشار على التأثير في قوات الأمن الأجنبية”. يرى العديد من المستشارين العسكريين الأميركيين أن العلاقة الشخصية مع الشركاء – التي كانت ذات مرة أداة يُفترض أنها تزيد من التأثير على الشريك وتشكيل سلوكه – هي الهدف الأساسي لتقديم المشورة. فعندما يفشل الإقناع، يُطلب من المستشارين تجنب القيام بأي خطوات قد تعرض هذه العلاقة للخطر. يقول أحد المستشارين الميدانيين السابقين: “كانت قوات التحالف في بغداد هي من يضع مقاييس الفعَّالية، كانت المقاييس عبارة عن أشياء غير ذات صلة، مثل: هل أن قوات الأمن العراقية مكتملة؟ وتكون الاجابات بالإجماع نعم، إنها مجهزة بالكامل وتضم عدداً كبيراً من أفراد الميليشيات” استمرت استراتيجية الإقناع القائم على الوئام هذه على الرغم من أن الولايات المتحدة في وضع جيد يسمح لها باستخدام حوافز للتأثير على شركائها في قوات الأمن. القادة في البلدان التي تنتشر فيها قوات أميركية غالباً ما يعتمدون، وبشكل كبير، على الولايات المتحدة من أجل ضمان أمن نظامهم، وفي كثير من الحالات، لضمان أمنهم الشخصي- والأميركيون يعرفون ذلك. الرئيس الفيتنامي الجنوبي نجو دينه ديم ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، وكلاهما استفاد بلداهما من برامج مساعدات عسكرية أميركية ضخمة، أعربا مراراً وتكراراً عن مخاوفهما من أن الولايات المتحدة على وشك الإطاحة بهما. (وهما كانا محقين في قلقهما: فالرئيس ديم قُتل في انقلاب عام 1963 بضوء أخضر من إدارة الرئيس الأميركي آنذاك جون كينيدي، والمالكي استقال في عام 2014 بعد أن فقد دعم إدارة باراك أوباما). فإذا لم تكن المخاوف الحادَّة من أن واشنطن قد تخرج أياً من قادة البلدان التي لها قواعد وقوات من السلطة في أي لحظة هي التي تعطي الولايات المتحدة النفوذ لتساوم على طاولة المساومة، فمن الصعب أن نتصور ما قد يحدث. البيروقراطية سيدة المواقف إذن، لماذا يُصر الجيش الأميركي على الإستمرار في إستراتيجية تقديم المشورة التي لا تُجدي نتيجة؟ وعلى غرار معظم البيروقراطيات الكبيرة في العالم، يميل الجيش الأميركي إلى إضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات تخدم مصالحه – في حالتها، الاستقلالية، المكانة، الهيبة والوصول إلى الموارد. يضع الجيش معايير ومقاييس تشغيلية تُعزز مصالحه البيروقراطية، يتمسك بالالتزام بها ويعمل على إبقائها ثابتة، خصوصاً أمام محاولات القادة المدنيين الأميركيين لتغييرها (…). إن ميل الجيش الأميركي إلى الإعلان بإستمرار عن التقدم الذي يُحرزه في مهماته الاستشارية الخارجية، على الرغم من الخلل الواضح في وظائف هذه المهمات، يخدم أغراضاً بيروقراطية مماثلة. فمن خلال تقديم سرد عن التقدم البطيء ولكن الثابت، فإن الجيش يحمي نفسه من النقد والتطفل والتدخل في استراتيجياته. وبتقدير جون سوبكو، المفتش العام الأميركي الخاص لإعادة إعمار أفغانستان، فان الجيش الأميركي “كان يعرف مدى سوء وضع الجيش الأفغاني، لكنه كان يغيّر باستمرار نقاط الهدف في تقاريره المرحلية لإظهار أن نجاحاً يتحقق – وحتى عندما كان يفشل، كان يتدخل في آلية تصنيف أدوات التقييم. إذا كان لديك ترخيص يؤهلك الإطلاع على حقيقة مجريات الأمور على الأرض، يمكنك معرفة [الحالة السيئة للجيش الأفغاني]، لكن المواطن الأميركي العادي، ودافع الضرائب العادي، وعضو الكونغرس العادي، والشخص العادي الذي يعمل في السفارة لن يعرف مدى سوء الوضع”. التقييمات المنحرفة للجهود الاستشارية الأميركية في أفغانستان ليست استثناء، بل “قاعدة” عامَّة لعمل القوات الأميركية في الخارج. في العراق، ركَّزت التقييمات العسكرية الأميركية على مقاييس مثل ما إذا كانت قوات الأمن العراقية لديها المعدات اللازمة والأفراد المُصرح لهم باستخدام تلك المعدات. هذه التقارير وفَّرت للجيش نظاماً لدعم إنتاجه الروتيني من التقارير المتفائلة التي تتحدث عن تقدم يُحرزه. غير أن قلَّة فقط من المستشارين الميدانيين في العراق كانوا يصدقون أن تلك التقييمات تعكس حقيقة حال القوات العراقية. في هذا الخصوص، يقول أحد المستشارين الميدانيين السابقين: “كانت قوات التحالف في بغداد هي من يضع مقاييس الفعَّالية، كانت المقاييس عبارة عن أشياء غير ذات صلة، مثل: هل أن قوات الأمن العراقية مكتملة؟ وتكون الاجابات بالإجماع نعم، إنها مجهزة بالكامل وتضم عدداً كبيراً من أفراد الميليشيات”. أثبت الضباط الأفغان أن اهتمامهم بمكافحة الفساد المستشري داخل حكومة كابول كان أقل بكثير من اهتمامهم بكيفية تأمين ثراءهم الشخصي، واختلاس الدولارات الأميركية لحساب شبكاتهم الخاصة بهم من خلال استغلال اتفاقية التعاقد وافتعال تهديدات ضد الشعب الأفغاني إن أوجه التشابه مع فيتنام ملفتة للنظر. فقد أعرب الجنرال ويليام ويستمورلاند، الذي كان قائداً للقوات الأميركية في فيتنام، بإستمرار عن أسفه لكون ضباط فيتنام الجنوبية لم يكونوا على درجة كافية من الكفاءة. ومع ذلك، يعتمد ويستمورلاند على نظام تقييم يستشهد بمقاييس مثل تزويد هؤلاء الضباط بسلاح الرشاش M16 كدليل على التقدم. كما أنه منع صراحة المستشارين الأميركيين من استخدام التهديدات لسحب فرقهم الاستشارية لتحفيز الضباط الفيتناميين غير المتعاونين بعد أن أدت محاولات القيام بذلك إلى استفزاز الصحافة في واشنطن لنشر تقارير تنتقد المؤسسة العسكرية الأميركية. “لقد حاول الجيش الأميركي عزل نفسه عن النقد الخارجي، وبعد ذلك قامت البيروقراطية بعملها”، بحسب ما جاء في تقرير لروبرت كومر (مسؤول سابق في الدفاع الأميركي) عن الحرب في فيتنام نشرته مؤسسة RAND عام 1972. في نهاية المطاف، الأمر متروك للقادة المدنيين لتوجيه وتنفيذ استراتيجية الاستشارات العسكرية للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن المعايير الحالية في العلاقات المدنية والعسكرية الأميركية تعني أن الجهود التي يبذلها الجيش الأميركي في التدريب والتجهيز تتبع نمطاً محزناً ومألوفاً. أولاً، يُكلف القادة المدنيون البنتاغون بالمهمة الصعبة- وربما المستحيلة في بعض الحالات- والمتمثلة في بناء قوات أمن في دول ذات مجموعات قومية أو دينية معينة محرومة من الجنسية. ثم تذعن أن الجيش الأميركي هو من نفذ برنامج المساعدة. ومع تزايد الأدلة على فشل الجيش المحلي، تزداد الشكوك والإحباط لدى القادة المدنيين الأميركيين، لكنهم عادة ما يتوقفون عن التدخل في ما يعتبرونه شؤوناً عسكرية. وبدلاً من ذلك، يتبنون التقارير المتفائلة التي يرفعها الجيش الأميركي، ويصادقون على التقييمات الواردة فيها والتي تروج لصورة وردية عن القوة المتزايدة للشريك المحلي – حتى ينهار كل شيء. درس كوريا هل يتكرر؟ قد تكون جهود المساعدات العسكرية في أفغانستان قد انتهت، لكن الجهود المبذولة لبناء قدرات شركاء الأمن المحليين تظل ركيزة لاستراتيجية الدفاع الأميركية. فإذا لم تتعلم الولايات المتحدة الدروس من الإخفاقات المتكررة لبعثاتها الاستشارية، فلا ينبغي لها أن تتوقع نتيجة مختلفة لجهودها المستمرة. بعض العلماء والمهنيون طرحوا مجموعة متنوعة من الوصفات التي لن تفعل الكثير لمعالجة جوهر العلَّة. إن استثمار المزيد من الأموال والموارد في المهمات الاستشارية العسكرية لن يُجدي نفعاً طالماً أن القادة المحليين يفتقرون إلى الاهتمام ببناء جيوش فعَّالة. ومن شأن الجهود الرامية إلى الحدّ من اعتماد الشركاء المحليين على الدعم الجوي الأميركي وغيره من عوامل التمكين أن تعالج جزءاً صغيراً فقط من المشكلة، بينما ستبقى القضية الأساسية المتمثلة في غياب العزم المحلي. إن إطالة جولات المستشارين وجذب كبار الموظفين لن يُحدث فرقاً كبيراً إذا استمر هؤلاء المستشارون في الاعتماد على سلطاتهم الإقناعية وحدها لإقناع القادة المحليين بتعزيز جيوشهم. واعتماداً على طبيعة التهديد وكيفية تناسبه مع السياسة الخارجية الأوسع للولايات المتحدة، قد لا يكون بناء جيش كبير ومهني أمراً ممكناً ولا ضرورياً. وفي بعض الحالات، قد يكون من المفيد أكثر أن تركز الولايات المتحدة على بناء عدد قليل من الوحدات الفعَّالة التي تهدف إلى العمل بدعم أميركي. بالنسبة للمهام الاستشارية المقرر الاستمرار فيها في المستقبل، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن استراتيجيتها المريحة للغاية، وأن تجمع بدلاً من ذلك بين الإقناع والتطبيق المنهجي للحوافز. وللإلهام، يمكن للمسؤولين اللجوء إلى واحدة من أفضل دراسات الحالة لهذا النهج: جهود الجيش الأميركي الثامن لتدريب جيش كوريا الجنوبية من عام 1948 إلى عام 1953. فحتى بعد غزو كوريا الشمالية في عام 1950، كان القادة السياسيون والعسكريون في كوريا الجنوبية ممزقين بين الدوافع الوطنية والفردية بطريقة أضعفت قوتهم العسكرية. ولكن على عكس الجيش الأميركي اليوم، اتخذ الجنرالات والمستشارون التكتيكيون الأميركيون في ذلك الوقت نهجاً حازماً: فقد تولى الجنرال جيمس فان فليت، قائد الجيش الأميركي الثامن، القيادة المباشرة لجيش جمهورية كوريا، وهدَّد بخفض المساعدات في محاولة لضمان ترقية الضباط الأكفاء إلى القيادات الرئيسية وإبقاء الجيش معزولاً عن التسييس. وعلى المستوى التكتيكي، سعى المستشارون العسكريون الأميركيون التابعون للمجموعة الاستشارية العسكرية الكورية بالمثل إلى إلهام وإقناع نظرائهم الكوريين الجنوبيين، ولكن عندما فشل الإقناع، هدَّدوا بقطع وحدات كوريا الجنوبية عن الإمدادات الأميركية لتحفيز الضباط على اتباع توجيهاتهم. وبحلول العام 1952، بالكاد تمت ترقية ضابط واحد في الجيش الكوري الجنوبي من دون موافقة الجيش الثامن للولايات المتحدة. وبحلول منتصف العام 1953، تحول الشريك المحلي إلى قوة قتالية فعَّالة. هناك دائماً عوامل معقدة وقيود على المقارنة بين الحالات. بنى الجيش الأميركي جيش جمهورية كوريا الجنوبية في زمان ومكان مختلفين، وكان مُعداً لمواجهة تهديدات مختلفة عمَّا تواجهه الولايات المتحدة اليوم في أفغانستان والعراق. ومن المرجح أن يكون النهج الحازم للجيش الأميركي في كوريا قد تشكل من خلال حقيقة أن الفرق الأميركية بأكملها كانت معرضة لإبادة جماعية عند الخطوط الأمامية فيما لو انهار جيش كوريا الجنوبية – وهو تهديد مادي فوري لأرواح الأميركيين لن يتكرر في الحروب المستقبلية. وعلى الرغم من أن خيار القيادة المباشرة للجيوش الشريكة بأكملها قد يكون غير مطروح الآن بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن هناك الكثير الذي يمكن للجيش الأميركي أن يتعلمه من تجربته في كوريا. على وجه الخصوص، يمكن أن يأخذ درساً بأن الإقناع القائم على الوئام لم يكن وحده هو الذي أحدث تحولاً في جيش جمهورية كوريا، ولكن أيضاً التطبيق المنهجي للحوافز. يمكن لمثل هذا النهج أن يزيد من فعَّالية بعض مشاريع المساعدات المقدمة لقوات الأمن. لكن الولايات المتحدة لديها أيضاً خيار آخر: فهي تستطيع تقليص جهودها في التدريب والتجهيز. وبدلاً من استخدام البعثات الاستشارية كخيار مفضل لمواجهة التهديدات الأمنية المحلية، يمكننها أن تحتفظ بمثل هذه البرامج لدول ذات مؤسسات وطنية قوية، ولديها اهتمام واضح ببناء جيوش أفضل. سيؤدي هذا المسار إلى إنهاء معظم مشاريع المساعدات العسكرية الأميركية، بما في ذلك الجهود المستمرة لبناء قوات الأمن العراقية. في كثير من الأحيان، كانت جهود الولايات المتحدة لتدريب وتجهيز الجيوش الأجنبية مدفوعة بالمنطق البيروقراطي وليس بالإستراتيجية السليمة. لقد كشف سقوط كابول عما هو أكثر من العفن داخل الجيوش التي تبنيها الولايات المتحدة. كما كشف عن العفن والفساد داخل نهج الولايات المتحدة”.